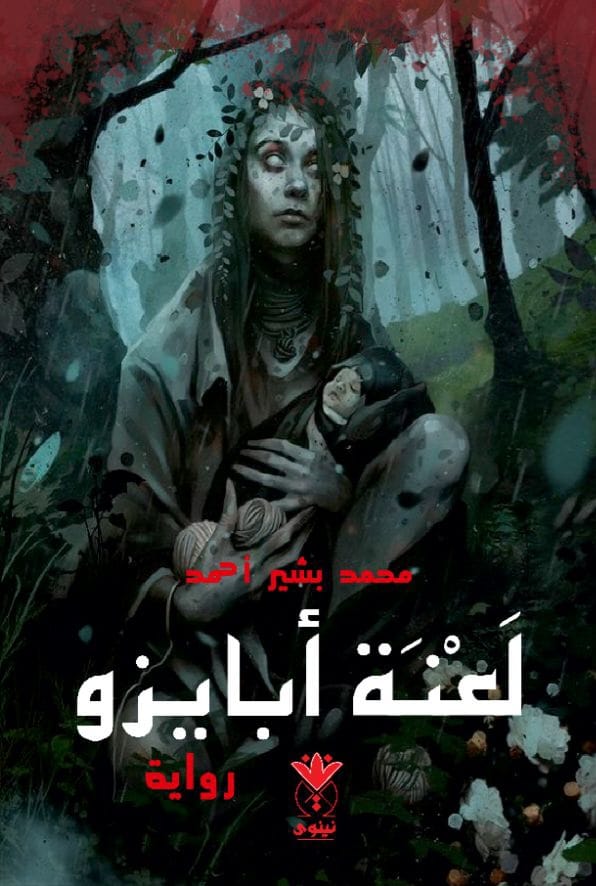بقلم / عبدالعليم حريص
للثقافة عدة مضامين تشكل بها وعي أي إنسان أو مجتمع أو حتى حضارة بأكملها، ومن هذا المنطلق الراديكالي يمكننا القول بأن المقياس الحقيقي للحضارات هو الوعي، ولو أسقطنا ذلك على الأدب لتجلى لنا بكل سهولة مدى ما يعانيه الأدباء في خلق ثقافة مغايرة عن الوعي العام الذي شكل شخصيتهم وصبغ أفكارهم وجعلهم نسخة واحدة في أجساد متعددة، فلا فرق يلحظ بين أفراد مجتمع ما حين يتعلق الأمر بمكانتهم التي ولدوا بها، وكم يتمنون أن يستمروا عليها ويورثها لأبنائهم، ولكن الأديب يبادر بإيجاد ما لا يوجد من ثقافة لم يكن للوعي العام أثر فيها، ومن هنا يمكننا القول بأن هذا يعد عرفياً بالثقافة المضادة، يا لها من جملة مخيفة في مجتمعاتنا، ولكن وبقليل من التركيز نلاحظ أن الثقافة المضادة التي تتسق مع الثقافة العامة في جزء وتختلف في تطبيق، هي مقياس للحياة بأسرها، فكافة الأديان التي ظهرت للبشرية هي لا تعدو أن تكون ثقافة مضادة للسائد وقتها، ولكن تختلف باختلاف تطبيق هذه الثقافة المتبناة من قبل شخص أو جماعة، فلا تجود ديانة سماوية لا تأخذ الأساسيات من التي قبلها، وحتى قبل الأديان كانت القيم الإنسانية هي من تحرك المجتمعات ولكن وبعد فترة ما احتاج العالم لجمع القيم الخلقية والروحية في إطار واحد، هذا الإطار هو الدين، ومن منّا لا يدرك أهمية الدين وأثره في المجتمعات البشرية؟
أما في الأدب فالأمر يختلف لأن السائد كما قال طه حسين الأدب لا يخضع للأخلاق باعتبار أن الأخلاق تمثل الوعي العام الديني لأي مجتمع.
هذا على خلاف ما يعرف بالثقافة المضادّة على أنها ثقافة فرعية مشتركة بين مجموعة من الأفراد الذين يميزون أنفسهم بمعارضة واعية ومتعمّدة للثقافة السائدة. والظاهر أنّ هناك اختلافا بينها وبين الثقافة الفرعية، فحسب «موسوعة علم الإنسان» فإنّ الثقافة المضادّة، «ظاهرة تنمو في مواجهة المعايير والقيم التقليدية أو الخاصّة بالأغلبية، وترتبط بمعايير وقيم المجتمع أو جماعة اجتماعية بديلة، ولهذا تختلف الثقافة المضادّة عن الثقافة الفرعية التي ليست سوى تنويعة من الثقافة السائدة، ولكنّها ليست بالضرورة في تناقض ظاهر معها”.